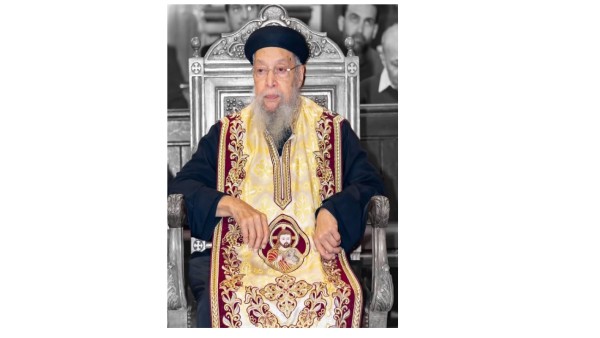في ظل إعلان وزير التربية والتعليم عن ضرورة بلوغ نسبة النجاح في مادة “التربية الدينية” 70% من العام المقبل، برزت في المقابل ظواهر سلوكية صادمة حدثت بالفعل في بعض المدارس، كان أبرزها واقعة اعتداء لفظي على مراقبة امتحانات، وُجهت لها إهانة عنصرية تمثلت في قول “يا مسيحية يا بنت ال*****”، ناهيك عن حالات الغش الفردي والجماعي.

وهنا يُطرح السؤال التالي بإلحاح: هل ستؤدي هذه النسبة إلى اختفاء مظاهر الغش وألفاظ التمييز الديني من قبيل “يا مسيحية يا بنت الـ…”، أم ستظل هذه السلوكيات حاضرة رغم النجاح؟
في سيناريو قادم، وبين سطور نسب النجاح ومفاهيم المواطنة، قد يُفترض أن ارتفاع نسبة الاجتياز في “التربية الدينية” سيسهم في تعزيز الأخلاق والقيم.
لكن الواقع المحتمل قد يحمل تساؤلات تربوية لا مفر منها: هل يمكن لمادة تُعامل كحصة دراسية، وتُختصر في الحفظ والدرجات، أن تبني ضميرًا أخلاقيًا حيًا؟ وهل يكفي اجتياز اختبار في التربية الدينية دون ترجمة حقيقية لسلوك المواطنة، والرحمة، واحترام الاختلاف؟
وبحسب ما سيؤكده مراقبون تربويون في تلك المرحلة، فإن النجاح في المادة لن يعني بالضرورة أن الطالب قد اكتسب وعيًا دينيًا حقيقيًا، بل إن المناهج، ما لم تُدمج فيها القيم بشكل حي وتفاعلي، ستظل قاصرة عن معالجة جذور المشكلة.
ومع اتساع الفجوة المتوقعة بين “نسب النجاح” و”سلوكيات الواقع”، ستتجه أصوات تربوية إلى المطالبة بإعادة تعريف أهداف مادة التربية الدينية، وربما دمجها ضمن رؤية أشمل لـ”التربية على المواطنة”، مع تعزيز حضورها في اليوم الدراسي، لا باعتبارها مجرد رقم في شهادة، بل باعتبارها مرآة لما سيكون عليه الضمير الجمعي للمجتمع.
في ظل هذه المعطيات، سيبقى الرهان على المستقبل معقودًا ليس فقط على نسب النجاح، بل على مضمون ما يُدرس، وكيفية تفعيله، والأهم من ذلك: ما إذا كنا نربّي على الدين… أم نُدرّس الدين فقط.